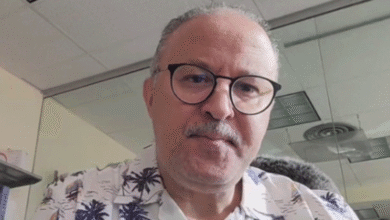بوغطاط المغربي | حرب الوعي السيادي.. حرب كل المغاربة الحلقة 4: افتعال صراع الأجنحة.. بروباغندا رخيصة لتفكيك الثقة بين المؤسسات
بوغطاط المغربي | حرب الوعي السيادي.. حرب كل المغاربة الحلقة 4: افتعال صراع الأجنحة.. بروباغندا رخيصة لتفكيك الثقة بين المؤسسات

من بين أخطر أدوات صناعة السُّخط والتضليل في السياق السياسي المغربي، تبرز سردية “الدولة الموازية” وسردية “الصراع داخل الدولة” كأداة مركزية في هندسة خطاب الشك والتشويش. هذا المفهوم، المستورد في الأصل من أدبيات الأنظمة السلطوية المتآكلة، تحول في السنوات الأخيرة إلى سلاح دعائي يُستعمل في تقويض الثقة بين المؤسسات السيادية، عبر تأجيج وهم الصراع الداخلي وخلق انطباع بأن القرار الوطني مخترق من داخل الدولة نفسها.
في المغرب، أخذ هذا الخطاب شكلا متطورا عبر الترويج لمفهوم “الدولة الموازية” أو “البنية السرية”، ومحاولة تصوير الأجهزة الأمنية – وخاصة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني – كقوة متغوّلة تنازع الملكية اختصاصاتها أو تدير البلاد من وراء الستار.الهدف من هذا الخطاب ليس فقط تشويه مؤسسة بعينها، بل إضعاف الثقة الجماعية في الدولة ككل، من خلال تصويرها ككيان منقسم، متصارع، ومخترق، بما يبرر – وفق سردية المؤامرة – أن أي إصلاح أو تغيير هو مجرد وهم.
تستند سردية “الدولة الموازية” إلى فرضية تزعم وجود جهاز غير خاضع للرقابة أو المحاسبة، يتحكم فعليا في دواليب الحكم ويعطل أي مشروع إصلاحي. هذا الخطاب في العمق يُعيد إنتاج نظرية المؤامرة في أبشع صورها، إذ يُحوّل كل قرار رسمي إلى مناورة من طرف “قوة خفية” داخل الدولة، ويُلغي بذلك أي إمكانية لتفسير الأحداث سياسيا أو مؤسساتيا.
في السياق المغربي، بدأت هذه النظرية تنتشر بعد 2011، ثم عادت بقوة في السنوات الأخيرة، خاصة بعد بروز دور المؤسسة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتحقيق نجاحات نوعية على الصعيدين الوطني والدولي. عند هذه النقطة تحديدا، بدأ الخطاب المسموم يُصوّر المؤسسة الأمنية – وخاصة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني – كأنها “دولة داخل الدولة”، ويزعم أن تأثيرها يتجاوز الحدود الأمنية إلى “التأثير على القرارات السياسية”، بل حتى على المؤسسة الملكية نفسها، رغم أن هذه المؤسسة، أي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تشتغل في إطار الدستور والقانون وفي ولاء كامل للعرش والوطن وتناغم تام مع باقي المؤسسات الأمنية والعسكرية وتقع تحت وصاية وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة ومراقبة القضاء.
لا يمكن فهم هذا الخطاب دون التوقف عند الحملات المتكررة التي استهدفت عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والتي حاولت تصويره كـ”الرجل الأقوى”في الدولة، أو كطرف ينافس المؤسسة الملكية في الشعبية أو القرار، لأنه ببساطة أحد أبرز من أفشل مخططات محاولة اختراق المؤسسة الملكية والمس بالأمن القومي للمغاربة.
هذه الحملات، التي تقودها منصات إلكترونية من خارج المغرب، تعمل على زرع الشك في العلاقة بين المؤسسة الأمنية والملكية، رغم أن جلالة الملك نفسه كان السبّاق إلى نسف البذور الأولى لهذه السردية التي حاول البعض على زرعها إبان أحداث الحسيمة، حيث أكد جلالة الملك في خطاب 29 يوليوز 2017 على وحدة القرار الأمني والسيادي الوطني، نافيا جلالته بشكل قاطع وجود أي صراع أجنحة أو تيارات داخل الدولة.
ومما جاء في خطاب جلالة الملك أن قال جلالته: “]…[بل هناك من يقول بوجود تيار متشدد، وآخر معتدل، يختلفان بشأن طريقة التعامل مع هذه الأحداث. وهذا غير صحيح تماما.والحقيقة أن هناك توجها واحدا، والتزاما ثابتا، هو تطبيق القانون، واحترام المؤسسات، وضمان أمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم.
ويعرف المغاربة بأن أصحاب هذه الأطروحة المتجاوزة يستغلونها كرصيد للاسترزاق، وكلامهم ليست له أي مصداقية. وكأن الأمن هو المسؤول عن تسيير البلاد، ويتحكم في الوزراء والمسؤولين، وهو أيضا الذي يحدد الأسعار، الخ…في حين أن رجال الأمن يقدمون تضحيات كبيرة، ويعملون ليلا ونهارا، وفي ظروف صعبة، من أجل القيام بواجبهم في حماية أمن الوطن واستقراره، داخليا وخارجيا، والسهر على راحة وطمأنينة المواطنين وسلامتهم.”
إن ترويج هذه المزاعم ليس مجرد اختلاف في الرأي، بل يُعدّ عملا هداما يستهدف تفكيك وحدة القرار السياسي وتشويش صورة الدولة في الخارج، ويصب في مصلحة خصوم المغرب الذين يسعون لضرب استقراره من الداخل عبر الفوضى الرمزية.
في البداية، يتم الترويج لفكرة “تغوّل الأجهزة الأمنية”، عبر الاستشهاد بمزاعم مفبركة أو تقارير حقوقية انتقائية ومخدومة تُبتر من سياقها. ثم تُربط هذه الأجهزة بشخصيات بعينها، غالبا ما يُستهدف فيها عبد اللطيف حموشي، بتلميحات تتعلق بـ”النفوذ”، أو بـ”السيطرة”. وبعدها، يُقدَّم الملك وكأنه “رهينة” في نظام تديره جهات أخرى، في محاولة لإسقاط الرمزية الملكية من موقع الضامن لوحدة الدولة والمؤسسات.
في هذا الإطار، تعمد شخصيات مثل حميد المهداوي، المعطي منجب، سليمان الريسوني، فؤاد عبد المومني، هشام جيراندو، وعلي المرابط وآخرين، إلى إعادة تدوير هذا الخطاب. تارة بالتصريح، وتارة بالتلميح. كما تشارك فيه منصات مشبوهة تتلقى دعما خارجيا، منها من تعمل ضمن شبكات إعلامية موجهة، وأخرى تتستر خلف “مقالات رأي” و”تحليلات استراتيجية”.
وفي الخلفية طبعا، تعمل جماعة العدل والإحسان وبعض أطياف اليسار العدمي على توظيف هذه السردية كجزء من مشروعها العلني لتقويض شرعية النظام السياسي برمته، وهي تستثمر – بشكل صريح – في فكرة “الدولة الظل” للتشكيك في الانتخابات والبرلمان والقضاء والأمن، مع ما لذلك من أثر على تعبئة الشارع ضد رموز الدولة.
إن ربط هذه الحملات ببعض الأجندات الخارجية – سواء من جهات معروفة بعدائها للمغرب مثل النظام الجزائري، أو من مراكز نفوذ فرنسية تسعى لإعادة تشكيل موازين القوة أو حتى أوساط إماراتية ظهرت بصماتها مؤخرا في ملف حيجاوي– بات مسألة أمن وطني. فاختراق الثقة بين المؤسسات هو الخطوة الأولى في أي عملية تفكيك ناعم للدولة.
الخطير في هذا الخطاب أنه لا يبقى في مستوى ضيق، بل ينتقل إلى عموم الرأي العام، خاصة في بيئة رقمية تغيب عنها أدوات التحقق والتفكيك النقدي. تصبح مزاعم “الدولة الموازية” مقبولة تلقائيا، وتُفسّر بها كل أزمة أو فشل أو قرار، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات، وخلق حالة لا يقين دائمة تُشجّع على العزوف السياسي، وتهيّئ الأرضية للعنف الرمزي، وربما لاحقا العنف المادي.
إن سردية “الدولة الموازية” ليست مجرد انحراف في التحليل السياسي، بل مشروع تفكيك رمزي ممنهج يهدف إلى هدم الثقة بين مكونات الدولة، وبالتالي تسهيل اختراقها من الخارج أو إسقاطها من الداخل. إن مواجهتها لا تكون بالتجاهل أو الصمت، بل بالتحليل والتفكيك والمواجهة المؤسساتية والإعلامية والمدنية وهي مسؤولية جميع المغاربة، كلٌّ من موقعه.
في الحلقة القادمة، سننتقل إلى بعد آخر لهذه الحرب الرمزية وهيالجريمة الإلكترونية العابرة للحدود، حيث سنتناول كيف تحولت منصات مثل يوتيوب وفيسبوك إلى أدوات للابتزاز السيادي، وكيف بات على الدول المستضيفة، مثل كندا، أن تتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذا التهديد المتنامي.